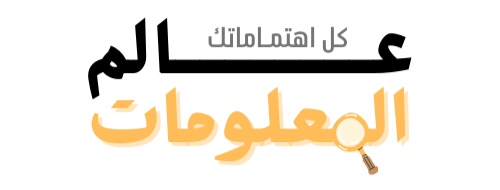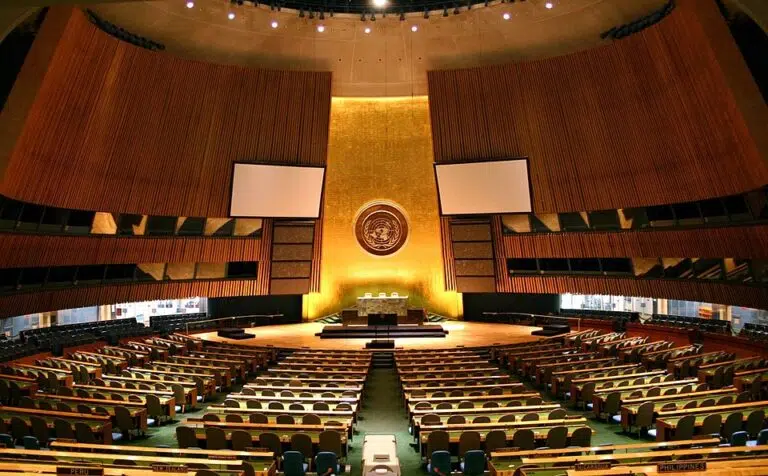تغطي المحيطات أكثر من 70% من سطح كوكبنا، وهي ليست مجرد مساحات مائية شاسعة، بل شرايين حيوية للتجارة العالمية، ومصدر غني بالموارد الطبيعية، وموطن لتنوع بيولوجي هائل، وساحة للتفاعلات الدولية المعقدة.
هذا الامتداد الأزرق اللامتناهي يثير تساؤلاً جوهرياً ظل يتردد عبر العصور: من يملك المحيطات حقًا؟ وهل يمكن لأي دولة أو كيان أن يدعي السيادة المطلقة على هذه الفضاءات البحرية الشاسعة؟ للإجابة على هذه الأسئلة، لا بد من الغوص في أعماق القانون البحري، واستكشاف الإطار القانوني الدولي الذي يسعى لتنظيم استخدام البحار والمحيطات والحفاظ عليها، وعلى رأسه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
يهدف هذا المقال إلى تقديم فهم شامل للقانون البحري، وتوضيح كيفية مساهمة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في تحديد “ملكية” وإدارة المحيطات، وتسليط الضوء على أبرز المنازعات على الجزر والمياه الإقليمية التي تشكل تحديًا دائمًا للسلم والأمن الدوليين.
ما هو القانون البحري؟ نبذة تاريخية وتطور
القانون البحري (Maritime Law)، المعروف أيضًا بقانون الأميرالية (Admiralty Law) في بعض الأنظمة القانونية، هو مجموعة شاملة من القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية والمحلية التي تحكم جميع الأنشطة البحرية والعلاقات القانونية المتعلقة بالسفن والملاحة والتجارة البحرية وحماية البيئة البحرية واستغلال موارد البحار.
تاريخيًا، تعود جذور القانون البحري إلى الحضارات القديمة التي مارست التجارة عبر البحار، مثل الفينيقيين واليونانيين والرومان. فقد ظهرت الحاجة مبكرًا لوضع قواعد لتنظيم سلوك السفن في البحر، وحل النزاعات المتعلقة بالشحن، وتحديد المسؤوليات في حالات الحوادث البحرية. من أبرز القوانين البحرية القديمة “قانون رودس البحري” (Lex Rhodia de Jactu)، الذي تناول مسائل الخسائر المشتركة.
مع توسع التجارة البحرية الأوروبية في العصور الوسطى وعصر النهضة، تطورت مجموعات أخرى من القوانين البحرية مثل “قوانين أوليرون” و “قوانين ويسبي”. ومع بزوغ الدول القومية، بدأت كل دولة في تطوير قوانينها البحرية الخاصة، مما أدى إلى تضارب واختلافات.
في القرن السابع عشر، برزت مدرستان فكريتان رئيسيتان حول مسألة السيادة على البحار:
- مبدأ “البحار المغلقة” (Mare Clausum): دافع عنه مفكرون مثل جون سيلدن، ويقضي بحق الدول الساحلية في بسط سيادتها على مساحات واسعة من البحار المجاورة لها.
- مبدأ “حرية البحار” (Mare Liberum): روّج له الفقيه الهولندي هوغو غروتيوس، مؤكدًا أن البحار يجب أن تكون مفتوحة لجميع الدول للاستخدام الحر في الملاحة والتجارة.
ساد مبدأ “حرية البحار” تدريجيًا، لكن الحاجة إلى تنظيم الأنشطة المتزايدة والمتنوعة في المحيطات، خاصة مع التقدم التكنولوجي في القرن العشرين واكتشاف موارد النفط والغاز في قاع البحار، أدت إلى ضرورة وضع إطار قانوني دولي شامل.
دستور المحيطات: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)
بعد عدة محاولات ومؤتمرات دولية، تُوجت الجهود باعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (United Nations Convention on the Law of the Sea – UNCLOS) في عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994.
تُعتبر هذه الاتفاقية بمثابة “دستور للمحيطات”، حيث تقدم إطارًا قانونيًا شاملاً لجميع جوانب استخدام البحار والمحيطات ومواردها. وقد صادقت عليها الغالبية العظمى من دول العالم (أكثر من 168 دولة طرف، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي)، مما يمنحها قوة قانونية وعرفية واسعة النطاق.
تهدف UNCLOS إلى تحقيق توازن دقيق بين مصالح الدول الساحلية في السيطرة على المناطق البحرية المجاورة لها، ومصالح المجتمع الدولي ككل في حرية الملاحة والاستخدام السلمي للبحار. ومن أبرز ما نظمته الاتفاقية:
1. المناطق البحرية الخاضعة لولاية الدول الساحلية:
- المياه الداخلية (Internal Waters): تشمل المياه الواقعة على الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس للدولة الساحلية (مثل الموانئ والأنهار والخلجان). للدولة الساحلية سيادة كاملة على هذه المياه، تمامًا كسيادتها على إقليمها البري.
- البحر الإقليمي (Territorial Sea): يمتد حتى مسافة 12 ميلًا بحريًا (حوالي 22.2 كيلومترًا) من خط الأساس. للدولة الساحلية سيادة كاملة على بحرها الإقليمي، بما في ذلك الحيز الجوي فوقه وقاعه وباطن أرضه. ومع ذلك، تخضع هذه السيادة لحق المرور البريء (Right of Innocent Passage) للسفن الأجنبية، طالما كان مرورها سلميًا ولا يضر بأمن الدولة الساحلية. [صورة توضيحية لمناطق القانون البحري المختلفة]
- المنطقة المتاخمة (Contiguous Zone): تمتد لمسافة 12 ميلًا بحريًا إضافيًا وراء البحر الإقليمي (أي حتى 24 ميلًا بحريًا من خط الأساس). في هذه المنطقة، لا تتمتع الدولة الساحلية بسيادة كاملة، ولكن يمكنها ممارسة الرقابة اللازمة لمنع خرق قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالجمارك أو الضرائب أو الهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي، والمعاقبة على تلك الخروقات.
- المنطقة الاقتصادية الخالصة (Exclusive Economic Zone – EEZ): وهي منطقة ذات أهمية اقتصادية بالغة، تمتد حتى مسافة 200 ميل بحري (حوالي 370.4 كيلومترًا) من خط الأساس. في هذه المنطقة، تتمتع الدولة الساحلية بحقوق سيادية لأغراض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية (مثل الأسماك) وغير الحية (مثل النفط والغاز والمعادن) الموجودة في المياه وقاع البحر وباطن أرضه، وكذلك لإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. كما أن لها ولاية فيما يتعلق بإنشاء واستخدام الجزر الاصطناعية والمنشآت، والبحث العلمي البحري، وحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها. ومع ذلك، تحتفظ جميع الدول الأخرى بحريات الملاحة والتحليق ووضع الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، مع مراعاة حقوق وواجبات الدولة الساحلية.
- الجرف القاري (Continental Shelf): يشمل قاع البحر وباطن أرضه الذي يمثل الامتداد الطبيعي لإقليم الدولة الساحلية البري تحت سطح الماء. يمتد الجرف القاري للدولة الساحلية حتى الحافة الخارجية للهامش القاري، أو إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم تصل الحافة الخارجية للهامش القاري إلى تلك المسافة. وفي بعض الحالات الجيولوجية المحددة، يمكن أن يمتد الجرف القاري إلى ما بعد 200 ميل بحري، ولكن ليس أكثر من 350 ميلًا بحريًا من خط الأساس أو 100 ميل بحري من خط تساوي العمق 2500 متر. للدولة الساحلية حقوق سيادية على جرفها القاري لأغراض استكشاف واستغلال موارده المعدنية وغيرها من الموارد الطبيعية غير الحية في قاع البحر وباطن أرضه، بالإضافة إلى الكائنات الحية “الخاملة” (التي لا تتحرك إلا على قاع البحر أو تحته).
2. المناطق البحرية خارج نطاق الولاية الوطنية:
- أعالي البحار (High Seas): هي جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما. أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول، ساحلية كانت أم غير ساحلية. وتشمل حريات أعالي البحار، ضمن أمور أخرى: حرية الملاحة، حرية التحليق، حرية وضع الكابلات وخطوط الأنابيب البحرية، حرية بناء الجزر الاصطناعية والمنشآت الأخرى التي يجيزها القانون الدولي، حرية صيد الأسماك (مع مراعاة التزامات الحفظ)، وحرية البحث العلمي. لا يجوز لأي دولة أن تدعي إخضاع أي جزء من أعالي البحار لسيادتها.
- “المنطقة” (The Area): تشير إلى قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها خارج حدود الولاية الوطنية (أي خارج حدود الجرف القاري للدول الساحلية). أعلنت UNCLOS أن “المنطقة” ومواردها هي “تراث مشترك للإنسانية” (Common Heritage of Mankind). وهذا يعني أنه لا يمكن لأي دولة أن تدعي السيادة أو الحقوق السيادية على “المنطقة” أو مواردها، وأن استكشاف واستغلال هذه الموارد يجب أن يتم لصالح البشرية جمعاء، مع إيلاء اهتمام خاص لمصالح واحتياجات البلدان النامية.
3. إدارة الموارد وحماية البيئة البحرية:
تتضمن UNCLOS أحكامًا مفصلة بشأن حفظ وإدارة الموارد الحية، بما في ذلك التعاون بين الدول في هذا الصدد. كما تفرض على الدول التزامًا عامًا بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، ومكافحة التلوث البحري من جميع المصادر.
4. آليات تسوية المنازعات:
أنشأت الاتفاقية نظامًا شاملاً لتسوية المنازعات البحرية، بما في ذلك المحكمة الدولية لقانون البحار (International Tribunal for the Law of the Sea – ITLOS) ومقرها هامبورغ، ألمانيا، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم.
إذن، من يملك المحيطات حقًا؟
بناءً على ما سبق، يتضح أنه لا توجد دولة واحدة أو كيان واحد “يملك” المحيطات بأكملها. بدلاً من ذلك، أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نظامًا معقدًا ومتوازنًا من الحقوق والواجبات والولايات القضائية:
- الدول الساحلية تمارس درجات متفاوتة من السيادة والحقوق السيادية على المناطق البحرية المتاخمة لسواحلها (المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري). هذه الحقوق ليست مطلقة، بل مقيدة بالتزامات معينة تجاه المجتمع الدولي، مثل ضمان حق المرور البريء وحماية البيئة.
- أعالي البحار مفتوحة لجميع الدول للاستخدامات السلمية، ولا تخضع لسيادة أي دولة.
- “المنطقة” (قاع البحار العميقة) ومواردها تعتبر “تراثًا مشتركًا للإنسانية”، وتتم إدارتها من خلال السلطة الدولية لقاع البحار (International Seabed Authority – ISA) ومقرها جامايكا، لصالح البشرية جمعاء.
وبالتالي، فإن “ملكية” المحيطات هي مفهوم متعدد الأوجه، يجمع بين الولاية الوطنية على أجزاء منها، والمشاع العالمي على أجزاء أخرى، ومبدأ التراث المشترك للإنسانية بالنسبة لقاعها العميق. الهدف الأساسي هو ضمان استخدام المحيطات بشكل سلمي ومنظم ومستدام، مع تحقيق توازن بين مصالح الدول الفردية والمصلحة العامة للمجتمع الدولي.
بؤر التوتر: النزاعات على الجزر والحدود البحرية
على الرغم من الإطار الشامل الذي توفره UNCLOS، لا تزال المنازعات على الجزر والحدود البحرية تشكل مصدرًا رئيسيًا للتوتر وعدم الاستقرار في العديد من مناطق العالم. تكمن أهمية الجزر في أنها، وفقًا للمادة 121 من الاتفاقية، يمكن أن تولد مناطق بحرية خاصة بها (بحر إقليمي، منطقة متاخمة، منطقة اقتصادية خالصة، وجرف قاري)، تمامًا مثل الأراضي البرية.
ومع ذلك، فإن “الصخور التي لا يمكنها دعم سكن بشري أو حياة اقتصادية خاصة بها” لا تولد منطقة اقتصادية خالصة أو جرفًا قاريًا. هذا التمييز الدقيق أدى إلى العديد من الخلافات حول تفسير وضع بعض الجزر الصغيرة أو التكوينات البحرية.
تشمل أسباب النزاعات البحرية ما يلي:
- الخلافات التاريخية على السيادة على الجزر.
- تداخل المطالبات بالمناطق البحرية بين الدول المتجاورة أو المتقابلة، خاصة فيما يتعلق بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
- اكتشاف موارد طبيعية قيمة (مثل النفط والغاز ومصايد الأسماك الغنية) في المناطق المتنازع عليها.
- الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لبعض الممرات المائية والجزر.
من أبرز الأمثلة على المناطق التي تشهد نزاعات بحرية:
- بحر الصين الجنوبي: يشهد هذا البحر نزاعات معقدة بين الصين وعدد من دول جنوب شرق آسيا (مثل فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي) حول السيادة على مجموعات من الجزر والشعاب المرجانية (مثل جزر سبراتلي وباراسيل)، والمطالبات المتداخلة بالمناطق البحرية الشاسعة. أدى بناء الصين لجزر اصطناعية ومنشآت عسكرية في بعض هذه التكوينات إلى تصاعد التوترات. [صورة لجزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي]
- بحر الصين الشرقي: هناك نزاع بين الصين واليابان حول السيادة على جزر سينكاكو (تسميها الصين دياويو)، والتي تقع في منطقة غنية بالموارد المحتملة.
- بحر إيجة: يشهد نزاعات طويلة الأمد بين اليونان وتركيا تتعلق بتعيين حدود البحر الإقليمي والجرف القاري، ووضع بعض الجزر اليونانية القريبة من الساحل التركي.
- المحيط المتجمد الشمالي: مع ذوبان الجليد البحري بسبب تغير المناخ، تتزايد الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية للمحيط المتجمد الشمالي. تتنافس الدول المطلة على القطب الشمالي (روسيا، كندا، الولايات المتحدة، النرويج، الدنمارك عبر جرينلاند) على توسيع نطاق جرفها القاري والوصول إلى الموارد الطبيعية المحتملة وطرق الملاحة الجديدة.
توفر UNCLOS آليات لتسوية هذه النزاعات بالطرق السلمية، مثل المفاوضات المباشرة، أو الوساطة، أو اللجوء إلى المحكمة الدولية لقانون البحار أو محكمة العدل الدولية أو التحكيم. ومع ذلك، فإن حل هذه النزاعات غالبًا ما يتطلب إرادة سياسية قوية من جميع الأطراف المعنية.
التحديات ومستقبل الإدارة البحرية
يواجه القانون البحري والإدارة العالمية للمحيطات تحديات كبيرة في القرن الحادي والعشرين:
- الصيد الجائر والصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم (IUU Fishing): يهدد استدامة الأرصدة السمكية والتنوع البيولوجي البحري.
- التلوث البحري: بما في ذلك التلوث البلاستيكي، والنفايات الكيميائية، وتسربات النفط، مما يضر بالنظم البيئية البحرية وصحة الإنسان.
- تغير المناخ: يؤدي إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وتحمض المحيطات، وتغير أنماط التيارات البحرية، مما يؤثر على النظم البيئية الساحلية والبحرية.
- القرصنة والجرائم البحرية الأخرى: تهدد أمن الملاحة والتجارة البحرية.
- الحاجة إلى حماية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية: تجري حاليًا مفاوضات في إطار الأمم المتحدة لوضع صك دولي جديد ملزم قانونًا بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه المستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية (BBNJ).
- استغلال موارد قاع البحار العميقة: يثير مخاوف بيئية حول التأثير المحتمل على النظم البيئية الهشة في أعماق البحار.
يتطلب التعامل مع هذه التحديات تعزيز التعاون الدولي، وتطوير وتنفيذ القوانين واللوائح بشكل فعال، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا لفهم المحيطات بشكل أفضل وحمايتها.
ختاما
إن القانون البحري، وفي قلبه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثل إنجازًا تاريخيًا في سعي البشرية نحو تنظيم استخدام المحيطات الشاسعة بشكل سلمي وعادل ومستدام. لا “يملك” أحد المحيطات بالمعنى التقليدي للملكية، بل هناك نظام متطور من الحقوق والمسؤوليات المشتركة يهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والمصلحة العالمية.
على الرغم من التحديات والنزاعات المستمرة، توفر UNCLOS إطارًا لا غنى عنه لإدارة هذا “التراث المشترك للإنسانية”. إن مستقبل المحيطات، وبالتالي مستقبل كوكبنا، يعتمد على التزامنا الجماعي بمبادئ هذا القانون، وعلى قدرتنا على التعاون لمواجهة التحديات البيئية والأمنية المتزايدة.
إن فهمنا للقانون البحري ليس مجرد مسألة أكاديمية، بل هو ضرورة حيوية لضمان بقاء المحيطات كمصدر للحياة والازدهار للأجيال القادمة.
اكتشاف المزيد من عالم المعلومات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.