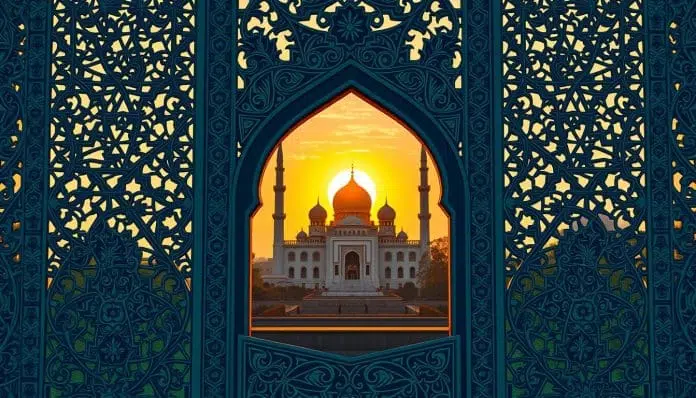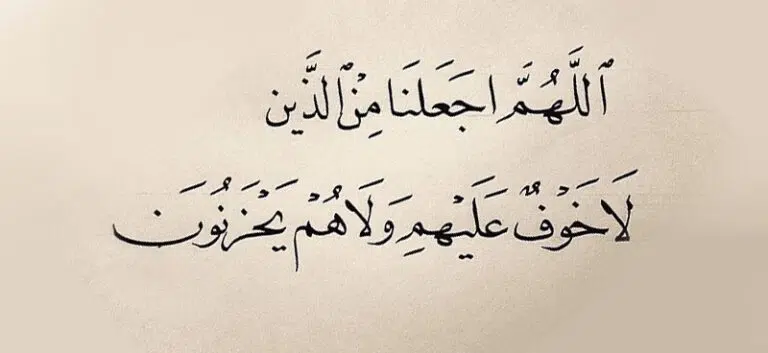لقد منّ الله سبحانه وتعالى على عباده بإرسال الرسل الكرام وإنزال الكتب السماوية المنيرة، وذلك رحمةً وهدايةً للعالمين، فأنزلها على صفوة خلقه من الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لتكون نبراسًا يهدي البشرية إلى طريق الحق والخير.
وغايتها السامية دعوة الناس قاطبةً إلى توحيد الله جلّ وعلا، الإقرار بربوبيته وألوهيته، ونبذ الشرك والكفر وكل ما يُعبد من دونه، وتحذيرهم من اتخاذ الأنداد والأوثان، والأمر بالإخلاص له في العبادة والطاعة، كما أنها جاءت لتحثّ المؤمنين على العمل الصالح واجتناب المعاصي والآثام والذنوب التي نهى الله عنها في كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين.
فبيّنت لهم طريق الخير وسبل الفلاح، وحذّرتهم من طريق الشر والهلاك، والإيمان بهذه الكتب السماوية التي أنزلها الله على رسله هو ركن أساسي من أركان الإيمان في ديننا الحنيف، إذ يوجب على كل مسلم الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم، والتصديق بما أنزل عليهم من وحي وهدايات، والتسليم بما جاء فيها من تعاليم وأحكام، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية السمحة، وذلك امتثالًا لأمر الله وطاعةً لرسله الكرام.
أهمية الإيمان بالكتب السماوية
يُعتبر الإيمان بالكتب السماوية السابقة، المنزلة من عند الله تعالى على أنبيائه ورسله الكرام، ركناً أساسياً وثابتاً من أركان الإيمان الحق، الذي لا يكتمل ولا يصح إلا بتحقيقه والتصديق به، إذ يُعدُّ هذا الإيمان تصديقاً بوحدة الرسالة الإلهية الخالدة، التي نزلت من منبع واحد هو الله عز وجل.
وتؤكد هذه الحقيقة أن دين الإسلام الحنيف هو الدين الجامع الشامل لكل ما سبقه من الشرائع السماوية، وهو المهيمن عليها والمصدق لما فيها من الحق، مصداقاً لقوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: 48].
وبناءً على ذلك، فإن المسلمين هم أولى الناس وأحقهم بقيادة البشرية وهدايتها إلى الصراط المستقيم، والسير بها على النهج القويم الذي رسمه الإسلام، وذلك لما يحملونه من رسالة عالمية شاملة، ولما يمتلكونه من فهم صحيح للدين الحق، وانطلاقاً من هذا الإيمان الراسخ، يوقن المؤمن المسلم بأن أي طائفة من أهل الكتاب، سواء كانوا من اليهود أو النصارى، يمتلكون أساساً وأصلاً لدينهم، وهو ما أنزله الله تعالى على أنبيائهم.
وهذا الأمر في حقيقته يُقرّب أهل الكتاب من الإسلام والمسلمين، ويُيسّر لهم فهمه واستيعابه، لو أنصفوا الحق واتبعوه، وتدبروا ما جاء به دين الإسلام من تصديق لما معهم من الحق، كما قال تعالى في محكم التنزيل: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلاَ تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى: 13]، ففي هذه الآية الكريمة بيان لوحدة أصل الدين الذي أوصى الله به جميع الأنبياء والمرسلين، وهو إقامة الدين وعدم التفرق فيه.
إنَّ الإيمان بالكتب الإلهية جزءٌ من الإيمان بالقرآن الكريم، وجزءٌ من الإيمان بأنَّ الله سبحانه هو الهادي، فما مِنْ أمةٍ إلا وقد أنزل الله بها هدًى، قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاَ فِيهَا نَذِيرٌ *} [فاطر: 24]. والمسلم يؤمن أنّ القرآن قد اشتمل على كلّ ما سبقه من كتب، وهو سليم من أي تحريف، فالقرآن يصدق بالكتب السابقة، وهو المرجع الوحيد لبيان ما فيها من حق، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ} [المائدة: 48].
والموقف الذي ينبغي أن يتّخذه المسلم من تلك الكتب «التوراة والإنجيل»، أن يؤمن بما ورد فيها مما قرره القرآن الكريم، أمّا ما وردَ مخالفاً أصول القرآن العامة فلا يؤمن به، بل يعتقدُ في بطلانه، أما ماعدا ذلك من القصص والمواعظ التي لم يذكرها القرآن، ولا تناقض أصوله فلا يصدقها ولا يكذبها، وذلك اتباعاً لما ورد عن النبي (ص): «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا امنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان حقاً لم تكذبوهم، وإن كان باطلاً لم تصدقوهم» .
تعداد الكتب السماوية
إنّ الإيمان بالكتب السماوية يتضمّن الإيمان بجميع الكتب، والذي ذُكر في المصادر الإسلامية من هذه الكتب هو خمسة كتب: القرآن الكريم، والإنجيل، والتوراة، وصحف إبراهيم والزبور، فهذه الكتب يجب الإيمان بها تفصيلًا، وما عداها يكون الإيمان به إجمالًا.
الزبور
الزبور هو الكتاب السماوي المُنزَّل من الله -جلّ وعلا- على نبيّه الكريم داود -عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم-، وهو من الكتب المقدسة التي أنعم بها الله على رسله الكرام هدايةً ورحمةً للعالمين، وقد ورد عن قتادة -رحمه الله تعالى- وهو من علماء التابعين الثقات، أنّ هذا الكتاب الجليل، يشتمل على مئة وخمسين سورة مباركة.
جُل هذه السور يدور في فلك المواعظ الحسنة التي تُرقّق القلوب وتُذكّر بالآخرة، والثناء العاطر على الله -سبحانه وتعالى-، بما هو أهله من كمال وجلال، والتسبيح بحمده وتمجيده وتقديسه، والإقرار له بالوحدانية المطلقة، والحمد له على نعمه الظاهرة والباطنة، وآلائه التي لا تُحصى، وليس في هذا الكتاب المُنزَّل بيان للأحكام الشرعية التفصيلية من تحليل ما هو حلال، وتحريم ما هو حرام، وبيان الحدود الشرعية المقررة للعقوبات، وتفصيل الفرائض العينية والكفائية.
وإنّما كان اعتماد النبي داود -عليه السلام- في التشريع والأحكام على ما سبقه من الشرائع السماوية، وبالأخص ما جاء في التوراة المُنزَّلة على أخيه موسى -عليه السلام-، فهي كانت الشريعة المُعتمدة في ذلك الوقت، فالزبور إذًا كتابُ ثناءٍ وتمجيدٍ وموعظةٍ، يُذكّر بالله -تعالى- ويُعلي ذكره.
صحف إبراهيم
إنَّ “الصحف” هي جمعٌ لكلمة “صحيفة”، وهي في الاصطلاح الديني تُطلق على الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء عليهم السلام. وصحف إبراهيم عليه السلام تحديدًا هي الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيّه وخليله إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وقد بيّن أهل العلم والاختصاص في هذا الشأن أنَّ غالب ما اشتملت عليه هذه الصحف المباركة كان من قبيل المواعظ الحسنة، والحكم البالغة، والعبر المؤثرة التي تهدي القلوب وتنير الدروب. وقد أفاد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الأمة، أنَّ صحف إبراهيم عليه السلام قد أُنزلت عليه من عند الله عز وجل، وقد تضمّنت هذه الصحف جملةً من المواعظ القيّمة والأحكام الشرعية التي تُنظّم حياة الناس وتُقيم العدل بينهم.
ومع ذلك، لم يصل إلينا شيءٌ مُفصّل ومُدوّن من هذه الأحكام على وجه القطع والجزم، إلا ما تواتر وثبت من أنَّ النبي إبراهيم عليه السلام كان قائمًا على التوحيد الخالص لله وحده، مُتمسّكًا بالملّة الحنيفية السمحة، وهي ملّة الإسلام التي هي دين الأنبياء جميعًا. وهذا المعنى قد أكّده القرآن الكريم في محكم آياته.
حيث قال الله تعالى في وصف نبيّه إبراهيم عليه السلام: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * شَاكِرًا لِّأَنْعُمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ}، فوصفه الله بأنه كان أمةً وحده لكمال إيمانه وقيامه بأمر الله، قانتاً لله أي مطيعاً خاشعاً، حنيفاً أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد الخالص، شاكراً لأنعم الله عليه، فاختاره الله واصطفاه وهداه إلى الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه.
التوراة
التوراةَ هي الكتابُ المُنزَّل من عندِ اللهِ -جلَّ جلالُه وتقدَّست أسماؤُه- على نبيِّهِ ورسولِهِ موسى -عليهِ أفضلُ الصلاةِ وأتمُّ التسليم-، وهيَ بمثابةِ النورِ المُبينِ والهدايةِ الرشيدةِ التي أنارَ اللهُ بها دروبَ بني إسرائيل، وقد جاءَ في مُحكمِ التنزيلِ، في سورةِ المائدةِ، قولُ الحقِّ تباركَ وتعالى: {إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ}.
فشملت هذه الآيةُ الكريمةُ بيانَ عِظمِ شأنِ التوراةِ وما اشتملت عليهِ من هُدىً ونورٍ، وأنَّها كانتْ مَحكَمةً وقضاءً يَحكُمُ بها الأنبياءُ الذينَ انقادوا لأمرِ اللهِ، وكذلكَ الربانيونَ والأحبارُ، وهمُ العلماءُ والقُضاةُ الذينَ أوكلَ إليهم حِفظُ كتابِ اللهِ وشَهِدوا عليهِ، والتوراةُ تُعتبرُ الركيزةَ الأساسيةَ وأصلَ الكتبِ السماويةِ التي أُنزلتْ على أنبياءِ بني إسرائيلَ من بعدِ موسى -عليه السلام-.
الإنجيل
الإنجيلَ هو كلامُ اللهِ جلّ جلالُه، وكتابُه المُنزّلُ على نبيِّه ورسولِه عيسى المسيح عليه من اللهِ أفضلُ الصلاةِ وأزكى التسليم، وهو نورٌ وهدىً أنزله اللهُ رحمةً للعالمين، ومُصدِّقًا لِما بين يديه من التوراةِ الشريفةِ التي أُنزلت على موسى كليمِ اللهِ عليه السلام، ومُتمِّمًا لأحكامِها ومُوَافِقًا لها في جوهرِها وأصولِها الشرعيةِ الغرّاء.
حيثُ يشتركان في الدعوةِ إلى توحيدِ اللهِ عزّ وجلّ، وإفرادِه بالعبادةِ والطاعةِ والخضوعِ، ونبذِ الشركِ والأوثانِ والأندادِ، وبيانِ سُبُلِ الخيرِ والفلاحِ في الدنيا والآخرةِ، فالإنجيلُ إذًا منحةٌ ربانيةٌ وهدايةٌ إلهيةٌ، جاءَ ليُضيءَ للناسِ طريقَ الحقِّ والاستقامةِ، ويُرشِدَهم إلى سواءِ السبيلِ، ويُذكِّرَهم بعظمةِ الخالقِ ووحدانيتِه، ويدعوهم إلى عبادتهِ وحده لا شريك له، ويُبشّرَ المؤمنينَ المُتّقينَ بجناتِ النعيمِ ورضوانِ اللهِ الكريمِ.
القرآن الكريم
إنّ القرآن الكريم هو كلام الله عزّ وجلّ، وهو النور المبين الذي أنزله رحمةً وهدايةً للعالمين على سيّدنا ونبيّنا محمدٍ صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ليُخرج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الحقّ والإيمان، وليكون لهم منهاجًا قويمًا ودستورًا شاملاً في جميع شؤون حياتهم.
يُعرّف هذا الكتاب المُعجز بأنّه اللفظ العربيّ البليغ الذي أعجز الفصحاء والبلغاء، وهو الوحي الإلهي الذي أوحاه الله تعالى إلى نبيّه المصطفى محمدٍ صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، حيث نزل به عليه مُنجّمًا على مدى ثلاثة وعشرين عامًا، وهو الكتاب المنقول إلينا جيلًا بعد جيلٍ نقلًا متواترًا لا يشوبه شكّ ولا ريب.
والمكتوب بين دفّتي المصحف الشريف الذي بين أيدينا، وهو المتعبّد بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، حيث تُعتبر قراءته عبادةً جليلةً وقربةً إلى الله تعالى، وهو الكتاب الذي افتُتح بسورة الفاتحة المباركة، أمّ الكتاب وركن الصلاة، واختُتم بسورة الناس التي تُعلّم الاستعاذة بالله من شرّ الوسواس الخنّاس.
اكتشاف المزيد من عالم المعلومات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.