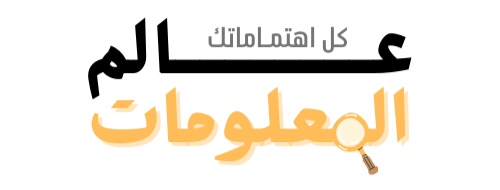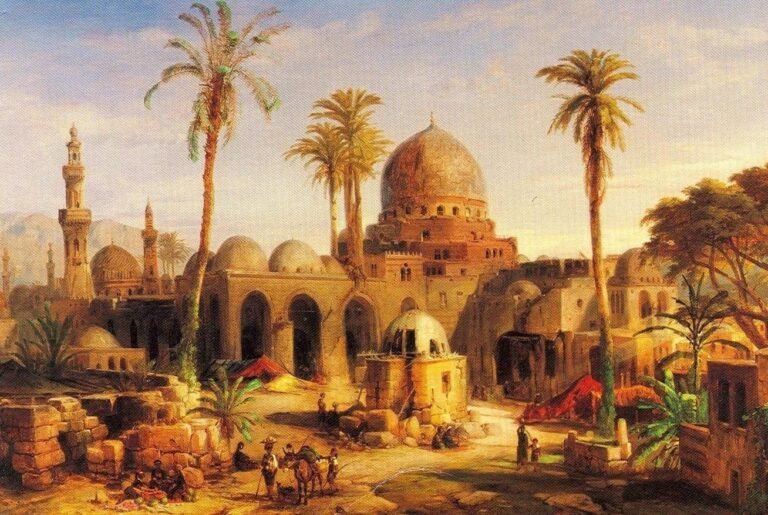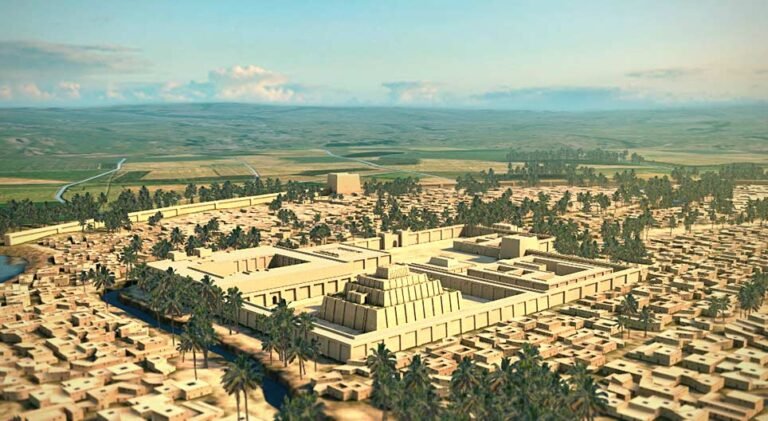في صيف عام 1914، انزلقت أوروبا، ومن ثم العالم، إلى صراع دموي لم يسبق له مثيل. أُطلق عليها في البداية “الحرب العظمى”، وقد حشدت إمبراطوريات بأكملها، وأعادت رسم خريطة العالم، وتركت وراءها ندوبًا لم تندمل بالكامل حتى يومنا هذا. وسط أهوالها التي لا توصف، ولدت عبارة مليئة بالأمل واليأس في آن واحد: “الحرب التي ستنهي كل الحروب”. كان هذا هو الاعتقاد السائد، أو على الأقل الأمل، بأن حجم المأساة سيكون صادمًا لدرجة أن البشرية لن تتجرأ أبدًا على تكرارها.
لكن التاريخ، بسخريته المعتادة، كان له رأي آخر. هذه الحرب التي كان من المفترض أن تكون الأخيرة، أصبحت بشكل مأساوي مجرد مقدمة لصراع أكثر دموية بعد عقدين فقط.
هذا المقال هو رحلة لاستكشاف أسباب اندلاع الحرب العالمية الأولى، وطبيعتها الوحشية التي ولدت هذا الأمل اليائس، وكيف أن السلام الذي أنهىها هو نفسه الذي زرع بذور الحرب التالية.
أسباب الحرب العالمية الأولى
لم تكن رصاصة واحدة هي التي أشعلت العالم، بل كانت مجرد شرارة سقطت على برميل بارود كان يمتلئ منذ عقود. كانت القوى الأوروبية الكبرى تعيش حالة من التوتر الشديد، تغذيها أربعة عوامل رئيسية متداخلة:
- نظام التحالفات المعقد: انقسمت أوروبا إلى معسكرين مسلحين. من ناحية، كان هناك الوفاق الثلاثي (Triple Entente) الذي يضم فرنسا، وبريطانيا، وروسيا. ومن ناحية أخرى، كانت هناك قوى المركز (Central Powers)، المتمثلة في الحلف الثلاثي (Triple Alliance) الذي يضم ألمانيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية، وإيطاليا (التي غيرت ولاءها لاحقًا). هذا النظام خلق تأثير الدومينو؛ أي هجوم على دولة واحدة كان يعني إعلان الحرب على حلفائها أيضًا.
- النزعة العسكرية (Militarism): شهدت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين سباق تسلح محموم بين القوى الأوروبية. كانت الجيوش تتضخم، وتطورت الأسلحة، وخاصة الأساطيل البحرية بين بريطانيا وألمانيا. أصبحت الحرب تُرى كأداة مشروعة لتحقيق الأهداف السياسية، وتم تمجيد القوة العسكرية في الثقافة الشعبية.
- الإمبريالية (Imperialism): كان هناك تنافس شرس على المستعمرات في إفريقيا وآسيا، ليس فقط من أجل الموارد والأسواق، بل أيضًا كرمز للمكانة والهيبة الوطنية. هذا التنافس خلق احتكاكات ونزاعات مستمرة بين الإمبراطوريات.
- القومية (Nationalism): كانت القومية قوة جبارة ذات وجهين. فمن ناحية، كانت هناك قومية شوفينية في الدول الكبرى، حيث تعتقد كل دولة بتفوقها. ومن ناحية أخرى، كانت هناك حركات قومية قوية بين الشعوب التي لا تملك دولة، خاصة في منطقة البلقان المضطربة. كانت مجموعات عرقية مثل الصرب تسعى للاستقلال عن الإمبراطورية النمساوية المجرية، مما جعل المنطقة “برميل بارود أوروبا”.
الشرارة التي أشعلت اللهيب: اغتيال في سراييفو
في 28 يونيو 1914، وفي مدينة سراييفو عاصمة البوسنة (التي كانت تحت سيطرة الإمبراطورية النمساوية المجرية)، أطلق طالب صربي قومي يُدعى غافريلو برينسيب النار على وريث عرش الإمبراطورية، الأرشيدوق فرانز فرديناند، وزوجته صوفي، فأرداهما قتيلين.
كان هذا هو الحادث الذي فجر كل التوترات المكبوتة. ألقت الإمبراطورية النمساوية المجرية باللوم على صربيا وقدمت لها قائمة من المطالب المهينة. وعندما رفضت صربيا بعض هذه المطالب، أعلنت النمسا الحرب عليها في 28 يوليو 1914. هنا، بدأ تأثير الدومينو المرعب:
- روسيا، حامية الصرب، بدأت في تعبئة جيشها.
- ألمانيا، حليفة النمسا، أعلنت الحرب على روسيا.
- فرنسا، حليفة روسيا، أعلنت الحرب على ألمانيا.
- عندما غزت ألمانيا بلجيكا المحايدة في طريقها لمهاجمة فرنسا، أعلنت بريطانيا الحرب على ألمانيا.
في غضون أسابيع قليلة، كانت القارة بأكملها في حالة حرب.
جحيم على الأرض: طبيعة الحرب العظمى
توقع الجميع أن تكون الحرب قصيرة وحاسمة، وأن يعود الجنود إلى ديارهم بحلول عيد الميلاد. لكنهم كانوا مخطئين بشكل مأساوي. سرعان ما تحولت الحرب، خاصة على الجبهة الغربية في فرنسا وبلجيكا، إلى كابوس لم يسبق له مثيل.
حرب الخنادق
توقفت الجيوش المتقدمة في مواجهة قوة النيران الدفاعية للمدافع الرشاشة والمدفعية. لحماية أنفسهم، حفر كلا الجانبين شبكات معقدة من الخنادق امتدت لمئات الكيلومترات من بحر الشمال إلى الحدود السويسرية. أصبح القتال عبارة عن حرب استنزاف وحشية، حيث كان الجنود يخرجون من خنادقهم ليشنوا هجمات عقيمة عبر “الأرض الحرام” (No Man’s Land) المليئة بالأسلاك الشائكة والحفر، فقط ليتم حصدهم بنيران المدافع الرشاشة. كانت الحياة في الخنادق جحيمًا من الطين، والجثث، والفئران، والأمراض، والخوف المستمر.
تكنولوجيا الموت
شهدت الحرب العالمية الأولى استخدام أسلحة جديدة ومروعة على نطاق واسع:
- المدافع الرشاشة والمدفعية الثقيلة: كانت مسؤولة عن غالبية الإصابات، وحولت ساحات المعارك إلى جحيم من النيران والشظايا.
- الغازات السامة: استخدم الألمان غاز الكلور لأول مرة في عام 1915، وسرعان ما تبعه غاز الخردل الأكثر فتكًا، مما أضاف بُعدًا جديدًا من الرعب للحرب.
- الدبابات والطائرات: ظهرت لأول مرة، وعلى الرغم من أنها كانت بدائية، إلا أنها بشرت بعصر جديد من الحرب الميكانيكية.
كانت معارك مثل معركة السوم (1916)، التي شهدت مقتل أو إصابة أكثر من مليون رجل، ومعركة فردان (1916)، رمزًا لهذه المذبحة الصناعية التي حصدت أرواح جيل كامل من الشباب الأوروبي.
السلام الذي خذل العالم: معاهدة فرساي
في 11 نوفمبر 1918، صمتت المدافع أخيرًا. انهارت قوى المركز، وانتهت الحرب بانتصار الحلفاء. اجتمع قادة الدول المنتصرة في باريس عام 1919 لصياغة معاهدة سلام، وأشهرها كانت معاهدة فرساي مع ألمانيا.
كان الأمل أن تكون هذه المعاهدة أساسًا لسلام دائم، لكنها كانت مدفوعة إلى حد كبير برغبة فرنسا وبريطانيا في الانتقام وإضعاف ألمانيا بشكل دائم. كانت شروطها قاسية ومهينة:
- بند “ذنب الحرب”: أُجبرت ألمانيا على قبول المسؤولية الكاملة عن اندلاع الحرب.
- التعويضات الباهظة: فُرضت على ألمانيا تعويضات مالية ضخمة للدول الحليفة، مما أدى إلى شل اقتصادها.
- القيود العسكرية الصارمة: تم تقليص حجم الجيش الألماني بشكل كبير، ومُنع من امتلاك أسلحة ثقيلة مثل الدبابات والغواصات.
- خسارة الأراضي: فقدت ألمانيا جميع مستعمراتها وأجزاء كبيرة من أراضيها في أوروبا.
الحرب التي مهدت لحرب أعظم
بدلاً من أن تكون “الحرب التي تنهي كل الحروب”، أصبحت الحرب العالمية الأولى هي السبب المباشر للحرب العالمية الثانية. لقد خلقت معاهدة فرساي ما أسماه المؤرخون “سلامًا لمدة عشرين عامًا”.
- الغضب الألماني: الشعور بالظلم والإذلال من معاهدة فرساي خلق أرضًا خصبة لصعود الحركات القومية المتطرفة. استغل سياسي ديماغوجي يدعى أدولف هتلر هذا الغضب، ووعد بإلغاء المعاهدة واستعادة كرامة ألمانيا.
- عدم الاستقرار الاقتصادي: أدت التعويضات الباهظة إلى تضخم جامح وانهيار اقتصادي في ألمانيا، مما ساهم في صعود النازيين إلى السلطة.
- فشل عصبة الأمم: على الرغم من تأسيسها لتحقيق السلام الدائم، إلا أن عصبة الأمم كانت ضعيفة وبدون سلطة حقيقية، وفشلت في وقف العدوان في ثلاثينيات القرن الماضي.
وهكذا، بعد 21 عامًا فقط من انتهاء “الحرب العظمى”، انزلق العالم مرة أخرى إلى صراع أكثر تدميراً وشمولية.
ختاما
لقب “الحرب التي ستنهي كل الحروب” لم يكن مجرد عبارة، بل كان صرخة ألم من جيل شهد فظائع لم يكن يتخيلها. كانت تعبيرًا عن أمل صادق في أن التضحيات الهائلة لن تذهب سدى. لكن التاريخ علمنا أن السلام لا يُبنى على الانتقام، وأن الظلم يولد المزيد من الظلم. الحرب العالمية الأولى لم تنهِ الحروب، بل علمتنا درسًا قاسيًا حول مدى سهولة انزلاق العالم المتحضر إلى الهمجية، وحول أهمية السعي لتحقيق سلام عادل وشامل، وهو درس لا نزال نكافح لاستيعابه بالكامل حتى اليوم.
لمزيد من المعلومات، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو الوثائقي عن الحرب العالمية الأولى. هذا الفيديو يقدم ملخصًا بصريًا لأحداث الحرب وتأثيرها، مما يساعد على فهم سياق المقال بشكل أفضل.
اكتشاف المزيد من عالم المعلومات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.