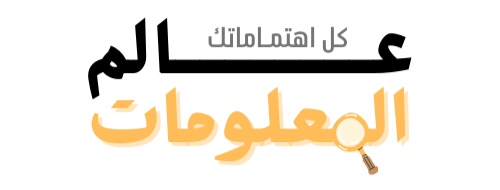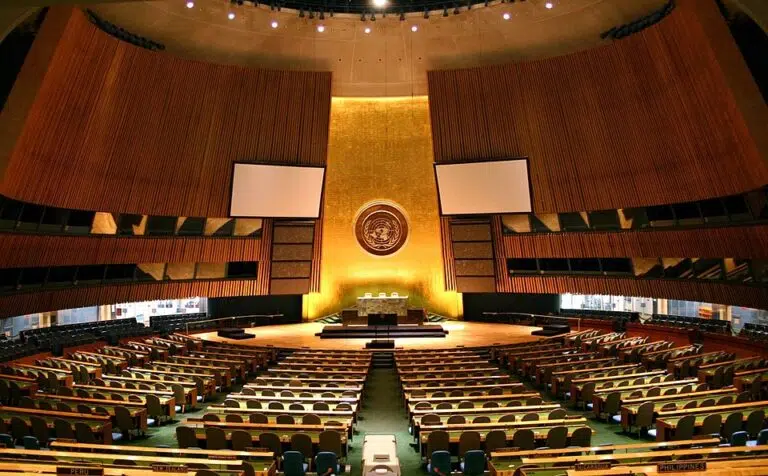الدستور، الذي يُطرح السؤال عنه مرارًا “ما هو الدستور؟”، يُمثّل حجر الزاوية في بناء الدولة الحديثة، فهو ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو العقد الاجتماعي الجوهري الذي يُرسي العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويُحدّد الإطار القانوني الأعلى الذي يُنظّم شؤون الدولة بأكملها.
هذا الإطار الدستوري، الذي يسمو على كافة القوانين واللوائح والأعراف الأخرى، يُعرّف بأنه مجموعة القواعد الأساسية التي تُحدّد نُظم الحكم في الدولة، وتُبيّن السلطات العامة فيها، من السلطة التشريعية المسؤولة عن سنّ القوانين، إلى السلطة التنفيذية المكلّفة بتطبيقها، وصولًا إلى السلطة القضائية التي تفصل في المنازعات وتضمن سيادة القانون.
هذه القواعد الدستورية لا تقتصر على تنظيم أعمال السلطات الثلاث وعلاقاتها المتبادلة فحسب، بل تتعدى ذلك لتنصّ بشكل واضح ومفصّل على حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتضع الضمانات اللازمة لحمايتها من أي تعدٍّ.
في هذا السياق، يهدف التوضيح الشامل لمفهوم الدستور إلى استكشاف جوانبه المتعدّدة، بدءًا من أنواع الدساتير المختلفة، سواء من حيث طبيعتها أو من حيث آليات تعديلها، وصولًا إلى مبدأ سمو الدستور الذي يُكرّس مكانته كأعلى سلطة قانونية في الدولة، ممّا يُساهم في فهم أعمق لكيفية تأثيره المباشر على حياتنا اليومية.
ما هو الدستور؟
الدستور، الذي يُرجَّح أن أصله فارسي ودخل العربية عبر التركية، ويعني التكوين أو التأسيس أو النظام، يُمثِّل جوهرَ القوانين والأنظمة التي تُؤسَّس عليها الدول لحلِّ مُشكلاتها. فهو عبارة عن مجموعة من المبادئ الأساسية التي تُنظِّم سُلطات الدولة وتُحدِّد صلاحياتها، وتُوضِّح حقوق الأفراد والجماعات على اختلاف تكويناتها واختصاصاتها، دون أي تأثير من المعتقدات الدينية أو الفكرية، ما يجعله مُلخَّصًا للطرق والوسائل التي تعتمدها الدولة في حلِّ قضاياها الداخلية والخارجية.
ويُحدِّد الدستور المبادئ والقواعد الأساسية لمختلف أشكال الدول وأنظمة الحُكم فيها، ويُنظِّم السلطات العامة وعلاقاتها ببعضها البعض، ويُوضِّح اختصاصات السلطات الثلاث: القضائية والتشريعية والتنفيذية، كما يُبيِّن واجبات وحقوق الأفراد والجماعات، ويضع الضمانات اللازمة لحمايتها. وبناءً على ذلك، يجب أن تتوافق جميع القوانين واللوائح مع القواعد والمبادئ الواردة في الوثائق الدستورية، ما يُرسِّخ مبدأ سمو الدستور وسيادة القانون.
أنواع الدساتير
للدساتير أربعة أنواع رئيسيّة مُقسَّمة إلى قسمَين، وِفق معيارَين رئيسيَّين، وهما:
من حيث المصدر
تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى:
الدساتير المُدوَّنة
يُعرَّف الدستور المُدوَّن بأنه ذلك الدستور الذي تُصاغ أحكامه من قِبل المشرِّع الدستوري وتُدوَّن في وثيقة رسمية واحدة أو في عدّة وثائق رسمية، بحيث تُشكّل هذه الوثائق الإطار القانوني الأساسي للدولة.
ويُمثّل هذا النوع الغالبية العظمى من دساتير دول العالم، حيث يُفضّل المُشرِّعون تدوين الدستور في وثيقة واحدة شاملة، على غرار الدستور الأردني والدستور المصري والدستور الأمريكي، ممّا يُسهّل الرجوع إليه وفهمه. ومع ذلك، قد يتطلّب الأمر في بعض الحالات إصدار الدستور في عدّة وثائق، كما حدث في دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة عام 1875 الذي صدر في ثلاث وثائق منفصلة، وذلك لاعتبارات تاريخية أو سياسية مُعيّنة.
ومن الجدير بالذكر أن الوثيقة الدستورية المُدوَّنة، سواء كانت واحدة أو مُتعدّدة، قد لا تتضمّن جميع القواعد والأحكام المُتعلّقة بممارسة السلطات العامة في الدولة، ممّا يستدعي وجود قوانين ولوائح أخرى تُعتبر مُكمّلة ومُفسّرة لأحكام الدستور، مثل القوانين المُتعلّقة بتنظيم عمل المجالس التشريعية وأنظمتها الداخلية، والتي تُساهم في توضيح آليات عمل السلطات وتفاعلها.
يُعتبر تدوين الدستور من أهم مظاهر الدولة الحديثة، حيث يُوفّر الاستقرار القانوني ويُحدّد صلاحيات السلطات ويحمي حقوق الأفراد، ممّا يُساهم في بناء دولة القانون والمؤسسات.
الدساتير غير المُدوَّنة
الدساتير غير المدونة، أو ما يُعرف أحيانًا بالدساتير العرفية، تُشكل نوعًا فريدًا من أنواع الدساتير يتميز بعدم تدوين قواعده وأحكامه في وثيقة رسمية واحدة. ينشأ هذا النوع من الدساتير عبر تراكم العادات والتقاليد الدستورية التي تتبعها الهيئات الحاكمة في الدولة على مر الزمن، حيث تُصبح هذه الممارسات المتكررة، المتعلقة بالمسائل الدستورية الجوهرية، بمثابة قواعد مُلزمة.
فبدلًا من أن تُوضع هذه القواعد من قبل مُشرّع دستوري في وثيقة مكتوبة، فإنها تستمد قوتها الإلزامية من قوة العرف الدستوري الذي يتشكل عبر استمرار الهيئات الحاكمة في تطبيقها والاعتقاد الراسخ بإلزامها، ما يُحوّلها إلى قواعد أساسية واجبة الاتباع من قِبل جميع سلطات الدولة.
هذه القواعد العرفية قابلة للتغيير أو التعديل عبر نشوء عرف دستوري جديد يُخالفها أو يُعدّلها، ويُعد الدستور الإنجليزي المثال الأبرز والأكثر شهرة على هذا النوع من الدساتير، حيث يُعتبر الدستور الوحيد غير المدون بشكل كامل في العصر الحديث، ما يجعله نموذجًا حيًا للدساتير التي تستمد شرعيتها وقوتها من العرف والممارسة الدستورية المُتوارثة.
من حيث إمكانيّة التعديل
تنقسم الدساتير من حيث إمكانيّة التعديل عليها إلى:
الدساتير المَرِنة
يُمكن تعريف الدستور المَرِن على أنّه: الدستور الذي يمكن التعديل عليه، أو إلغاؤه، كحال القوانين العاديّة الصادرة عن السُّلطة التشريعيّة (المجلس النيابيّ)؛ فهي تتيحُ إمكانيّة إجراء التعديلات، والتصحيحات إذا دَعَت الحاجة إلى ذلك، ومثال ذلك الدستور الإنجليزيّ الذي يُعتبَر دستوراً عُرفيّاً (غير مُدوَّن)، وفي الوقت نفسه دستوراً مَرِناً؛ حيث يمكن تعديله بإجراءات تعديل القانون العاديّ نفسها، كما أنّ هناك بعض الدساتير المُدوَّنة (المكتوبة) تتمتَّع بمرونة التعديل عليها، ومثال ذلك: الدستور الفرنسيّ، والإيطاليّ، والسوفيتيّ. وممّا سبق يتبيّن أنّ الدستور المَرِن يتميَّز بعدّة مُميِّزات، أهمّها:
- قد يكون الدستور المَرِن عُرفيّاً، أو مكتوباً؛ وهو بذلك يتلاءم مع الظروف التي يتطوَّر فيها المجتمع.
- قد تُؤدّي المرونة في الدستور إلى إضعاف قُدسيَّته، والتقليل من هيبته عند المُواطِنين، والسُّلطات الحاكمة.
- قد تدفع المرونة في الدستور، وسهولة التعديل عليه السُّلطة التشريعيّة إلى إجراء تعديلات ليست لها ضرورة.
الدساتير الجامدة
يُمكن تعريف الدستور الجامد على أنّه: الدستور الذي لا يُمكن تعديل نصوصه إلّا باتِّباع إجراءات أشدّ صرامة من التي يتمّ اتِّباعها في تعديل أحكام القانون العاديّ الصادر عن السُّلطة التشريعيّة، وتتمثّل مظاهر جمود الدستور بتحريم تعديل نصوصه في فترة مُحدَّدة، أو اشتراط إجراءات مُحدَّدة؛ للتعديل عليه، أو جمود بعض نصوصه بصفة مُطلَقة.
وبذلك قد تكون الدساتير جامدة مُطلَقاً، أو نسبيّاً، ويُقصَد بالجمود المُطلَق للدساتير: أنّ الدستور قابل للتعديل في أيّ وقت، والجمود لا يتعلَّق بالتعديل ذاته، بل بالطريقة التي يتمُّ فيها إجراؤه، أمّا الجمود النسبيّ للدساتيرن فهو يعني: جواز تعديل مختلف أحكام، ونصوص الدستور في أيّ وقت، وِفق الإجراءات التي ينصُّ عليها الدستور. ومن الأمثلة على الدساتير الجامدة المُدوَّنة (المكتوبة) الدستور المصريّ، وعلى الدساتير الجامدة غير المُدوَّنة (العُرفيّة) القوانين الأساسيّة للمملكة الفرنسيّة قَبْل ثورة 1789م. وممّا سبق يتبيّن أنّ الدساتير الجامدة لها عدّة مُميِّزات، من أهمّها:
- الاتِّفاق مع طبيعة القواعد الدستوريّة، ومع مكانتها من الناحية الموضوعيّة.
- إضفاء قَدر من الاستقرار، والثبات على أحكام الدستور؛ ممّا يجعلها بعيدة عن اعتداء المجلس النيابيّ.
أقدم الدساتير
يُعتبر مصطلح “الدستور” من المصطلحات المُعرَّبة التي تُشير إلى القواعد الأساسية التي تُشكِّل الدول وتُنظِّمها. ولتحديد أقدم الدساتير في التاريخ، يجب أولاً فهم مصادر الدساتير، والتي قد تنبثق من التشريعات الصادرة عن السلطات المختصة وفق إجراءاتٍ مُحددة، أو من الأعراف المُستقرَّة في وجدان الأفراد كقوانين عامة غير مكتوبة.
عند البحث في تاريخ الدساتير، يبرز دستور المدينة المنورة الذي وضعه النبي محمد -عليه الصلاة والسلام- في العام الأول للهجرة كأقدم دستور مكتوب للدولة، حيث يُعتبر هذا الدستور، الذي يُطلق عليه أيضاً اسم “الصحيفة” أو “الكتاب” تيمُّناً بكتاب الله، دستور الدولة العربية الإسلامية الأول.
وبالرغم من وجود بعض الوثائق القانونية التي تعود إلى عهد حمورابي حوالي عام 1750 قبل الميلاد، إلا أنها لم تكن شاملة أو مُفصَّلة مثل دستور المدينة المنورة، الذي وضع أسس الدولة الإسلامية ونظَّم علاقاتها الداخلية والخارجية.
مبدأ سمو الدستور
يُعدّ مبدأ سمو الدستور حجر الزاوية في النظام القانوني للدولة، حيث يتعلّق هذا المبدأ بشكل جوهري بمضمون وفحوى النصوص والقواعد الدستورية التي تُحدّد كيفية تنظيم ممارسة السلطة وتوزيعها بين مختلف هيئات الدولة، كما تُرسّخ هذه القواعد الفلسفة والأسس الأيديولوجية التي يقوم عليها النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ممّا يُضفي على الدستور مكانةً ساميةً باعتباره القانون الأعلى والمرجع الأساسي لجميع القوانين والأنظمة.
وبناءً على ذلك، يُصبح من الضروري أن يخضع نشاط الحكام وجميع الهيئات والمؤسسات في الدولة، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، لأحكام هذه القواعد الدستورية، إذ يُعتبر أي خروج أو تجاوز لهذه القواعد من قِبل أيٍّ من هذه السلطات مُخالفةً صريحةً لسند وجودها والأساس القانوني لاختصاصها، ويُمثّل بالتالي مساسًا جوهريًا بالدستور وانتهاكًا لسموه الموضوعي أو المادي.
كما يتضمّن مبدأ سمو الدستور أيضًا علوّه على جميع القوانين العادية واللوائح والأنظمة والأعراف السائدة في الدولة، ممّا يعني عدم جواز مُخالفة أي قاعدة قانونية دُنيا لأي من القواعد الدستورية، ويُعتبر أي خرق لهذا المبدأ انتهاكًا صريحًا لسمو الدستور الواجب التطبيق، وانطلاقًا من هذا المبدأ، يُمكن القول إنّ الدستور يُشكّل المصدر الأساسي والمرجعي لجميع السلطات العامة في الدولة، بما في ذلك رئيس الدولة والمجالس البرلمانية والتنفيذية والقضائية، فهو الذي يُحدّد صلاحياتها ويُرسم حدودها ويُضفي عليها الشرعية القانونية.
اكتشاف المزيد من عالم المعلومات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.