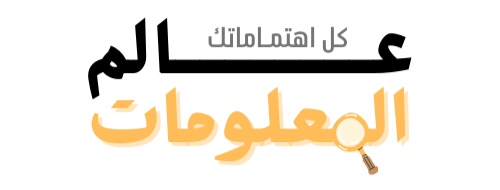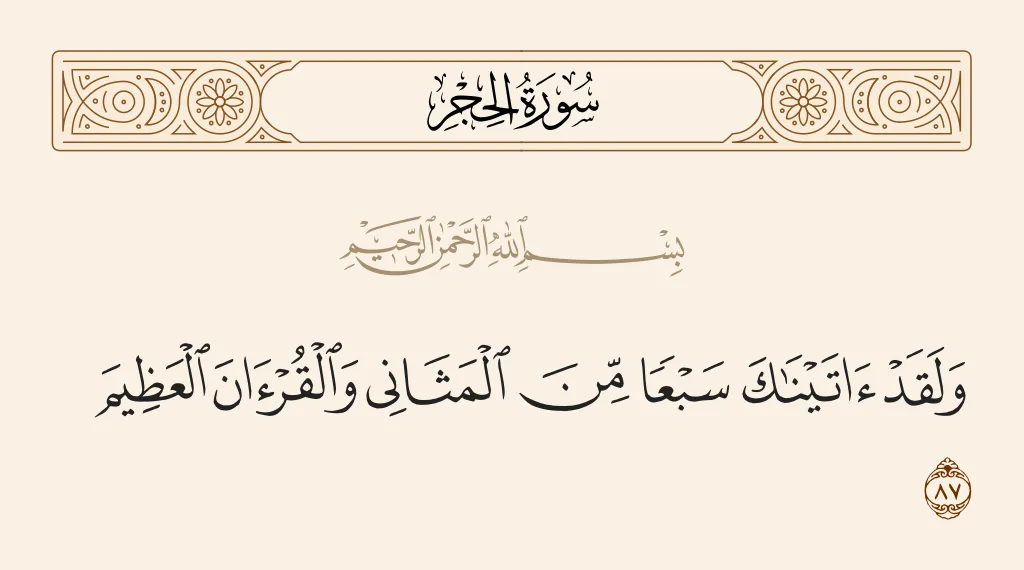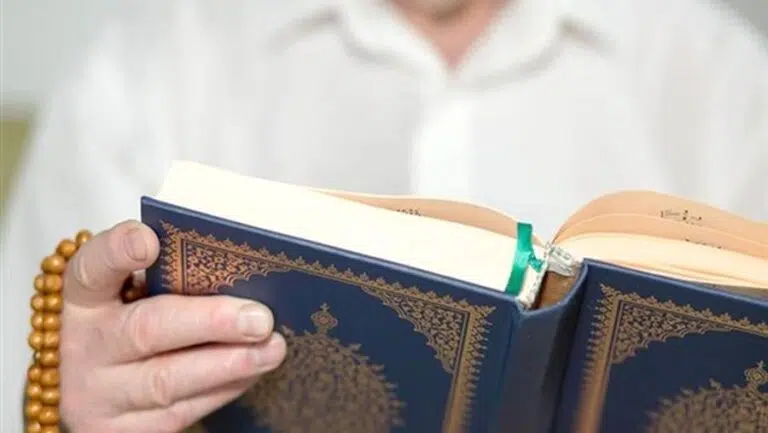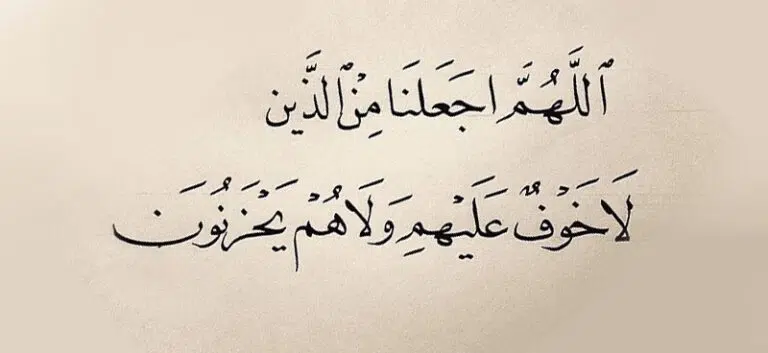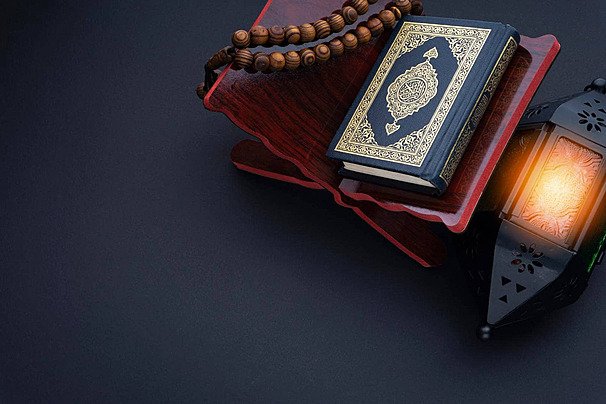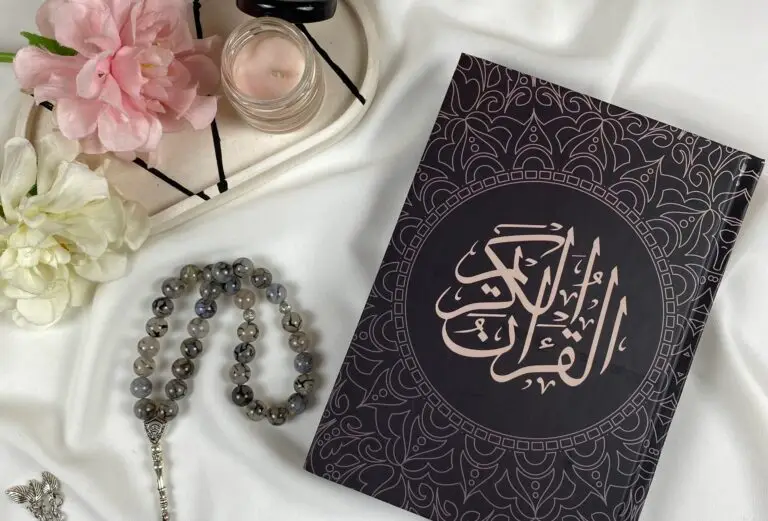ما هي السبع المثاني؟ لقد أوضح النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، المقصود بالتحديد من قول الله تعالى في كتابه الكريم: “وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ”، مبيناً أن المراد بذلك هو سورة الفاتحة المباركة، أم الكتاب وسيدة سوره. وجدير بالذكر أن أصل مصطلح “السبع المثاني” يرجع إلى لفظ “مَثنَى” أو “مُثَنَّى”، وهي صيغة لغوية تحمل معنى التكرار والترداد، ويعود السبب وراء تسمية هذه السورة الكريمة بهذا الاسم تحديداً إلى كونها تتألف من سبع آيات محكمات.
وقد بيَّنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الذي رواه أبو سعيد بن المعلى -رضي الله عنه- عندما قال: (لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هي أعْظَمُ السُّوَرِ في القُرْآنِ قَبْلَ أنْ تَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ. ثُمَّ أخَذَ بيَدِي، فَلَمَّا أرادَ أنْ يَخْرُجَ، قُلتُ له: ألَمْ تَقُلْ: لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هي أعْظَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ؟ قالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) هي السَّبْعُ المَثانِي، والقُرْآنُ العَظِيمُ الذي أُوتِيتُهُ)، فجاء إثبات ذلك في السُّنَّة النبويَّة.
سبب تسميتها بالسبع المثاني
سُميَّت سورة الفاتحة بالسبع المثاني لعدّة أسبابٍ كما يأتي:
- لأنَّها تشمل الحمد والثناء على الله -عزَّ وجل- وتعظيمه بما يستحقُّ.
- لأنَّ الصَّلاة لا تصحُّ إلَّا بها وتُكرَّر في كلِّ ركعةٍ منها.
- لأنَّها تضمُّ غايات القرآن ومعانيه جميعها، كما تُثنَّى فيها قصص القرآن وأسراره وأحكامه، قال -تعالى-: (اللَّـهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ).
- لأنَّ الله -تعالى- استثناها وميَّز بها رسالة الإسلام عن الرِّسالات السَّماويَّة الأخرى، فقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (والَّذي نَفسِي بيدِه، ما أُنزلَ في التَّوراةِ، ولا في الإنجيلِ، و لا في الزَّبورِ، ولا في الفُرقانِ مِثلِها، (يعني أمَّ القُرآنِ)، وإنَّها لسَبعٌ من المثانِي والقرآنُ العظيمُ الَّذي أُعطيتُه).
- لأنها تتضمَّن سبع آيات تُقرأ في كلِّ صلاةٍ.
المعاني التي اشتملت عليها سورة الفاتحة
حمد الله تعالى والثَّناء عليه وتمجيده
تتضمن سورة الفاتحة معاني جليلة وعظيمة، من أهمها حمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده، حيث تستهل السورة الكريمة بحمد الله عز وجل بما هو أهله، مؤكدةً على أن الحمد المطلق لا يستحقه إلا هو سبحانه، فلا معبود بحق سواه، ويتجاوز هذا الحمد مجرد اللفظ ليشتمل على الثناء عليه وتعظيمه في القلب والجوارح، وإرشاد الناس إلى هذا المنهج القويم في جميع جوانب حياتهم، سواء الدنيوية منها أو الأخروية.
ففي كل شأن من شؤون الحياة يتوجه المسلم إلى الله بالحمد والثناء، مع التوكل عليه وحده وابتغاء مرضاته بإخلاص العمل له، وهذا المعنى يتجسد في قوله تعالى: (الْحَمْدُ لِلَّـهِ)، حيث يثني المسلم على الله تعالى بلسانه وقلبه، قاصداً بذلك تعظيمه وتمجيده، ثم يتبع هذا الحمد بذكر صفتين من صفاته الحسنى وهما: (الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ)، حيث يصف الله نفسه بالرحمة على وجه المبالغة، فالرحمن أبلغ من الرحيم؛ لأنها تشمل رحمته في الدنيا والآخرة على السواء، بينما تختص صفة الرحيم بالرحمة في الآخرة بشكل أخص.
وقد جاء ذكر الرحمة بعد الحمد والثناء ليكون هناك جمع بين الترغيب والترهيب، فيرغب العبد في طاعة الله تعالى لما يرجوه من رحمته، وفي الوقت نفسه يرهب من معصيته خوفاً من عذابه، وهذا الأسلوب الحكيم يدفع العبد إلى الإقبال على طاعة الله والابتعاد عن كل ما يغضبه.
ثم يختتم هذا التقديم المهيب بقوله تعالى: (مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ)، ليؤكد على أن الله سبحانه وتعالى هو المالك المطلق لهذا الكون والمتصرف فيه، والقاضي في يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، فيوم الدين هو اليوم الذي يدان فيه العباد على أعمالهم، وهو يوم القيامة الذي يملك الله فيه الأمر كله.
إفراد الله تعالى بالعبادة والالتجاء
تشتمل سورة الفاتحة المباركة على معانٍ عظيمة وجليلة، من أهمّها وأبرزها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والالتجاء إليه وحده دون سواه، حيث يتجلّى هذا المعنى السامي في قوله تعالى: (إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ)، فهذه الآية الكريمة تُرسّخ مبدأ التوحيد الخالص لله عزّ وجلّ، وتُبيّن أنّه لا معبود بحقٍّ إلا هو، ولا يجوز صرف العبادة أو جزءٍ منها لأحدٍ غيره، مهما كان مقامه أو منزلته.
فالله وحده هو المستحقّ للعبادة المطلقة، والخضوع الكامل، والتذلّل الخالص، كما أنّ هذه الآية تُؤكّد على أنّ الله تعالى هو وحده الملجأ والملاذ، والمطلوب بالإعانة والتوفيق على أداء العبادة على أكمل وجه، فلا يجوز طلب العون أو المدد من أيّ مخلوقٍ كائناً من كان في الأمور التي هي من اختصاص الله تعالى، كالهداية والتوفيق والإعانة على الطاعات.
فالتوحيد بكلّ معانيه وأنواعه، من توحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، إنّما هو لله وحده، والرّجاء والأمل لا يكون إلّا فيه، والعبادة بكلّ أشكالها وصورها، ظاهرةً كانت أو باطنةً، قوليةً أو فعليةً، إنّما تُصرف له وحده لا شريك له، والاستعانة والتوكّل في كلّ شؤون الحياة، صغيرها وكبيرها، دقيقها وجليلها، إنّما تكون عليه وحده، فهو المُعين والمُيسّر والمُوفّق، وإليه يُلجأ في كلّ حالٍ، وهذا ما تُعلّمه لنا سورة الفاتحة وتُرشدنا إليه.
طلب الهداية إلى الصراط المستقيم
تتضمّن سورة الفاتحة المباركة معاني جليلة القدر، من أهمّها وأبرزها طلب الهداية إلى الصراط المستقيم؛ فالمسلم حين يقرأ هذه السورة العظيمة، وهي أمّ الكتاب، يتوجّه بقلبه ولسانه إلى الله سبحانه وتعالى، رافعاً أكفّ الضراعة، سائلاً إيّاه الهداية والتوفيق، والثبات على الاستقامة في هذه الحياة الدنيا، والسير على الطريق القويم الذي لا اعوجاج فيه، الطريق الذي يوصل سالكه إلى جنّات النعيم ورضوان الله الكريم في الآخرة.
فالمسلم في قوله: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ) لا يكتفي بمجرّد طلب المعرفة والدلالة على هذا الطريق فحسب، بل يتعدّى ذلك إلى الابتهال والتضرّع إلى الله عزّ وجلّ، راجياً منه أن يثبّته عليه، وأن ييسّر له سلوكه، وأن يعينه على تجاوز العقبات والصعاب التي قد تعترض طريقه، فهو يسأل الله تعالى أن يهديه إلى الصراط المستقيم، وأن يجعله من السائرين عليه حقّ السير، حتّى يفوز بالنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة.
ذكر أصناف النَّاس في الآخرة
ذكرت السُّورة في نهايتها أصناف النَّاس الثَّلاثة، على النَّحو الآتي:
- أهل النَّعيم: في قوله -تعالى-: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ)، أي الذين أنعم الله -تعالى- عليهم فهداهم، ومنهم من اختصَّه الله -تعالى- بالنبوَّة، والصِّديقين، وعباد الله -تعالى- الصَّالحين.
- المغضوب عليهم: هم الذين أشركوا مع الله -تعالى- إلهاً آخر، واشتروا الدُّنيا بدلاً من الآخرة، وارتكبوا الذُّنوب والمعاصي رغم علمهم بها وبما يأتي منها من غضب الله -تعالى- عليهم، وقال العديد من المفسّرين إنَّهم اليهود.
- الضَّالين: وهم الذين يرتكبون المعاصي والذُّنوب من غير علمٍ لهم بإثمها، وقال العديد من المفسّرين إنَّهم النَّصارى، ويدخل اليهود ضمن المغضوب عليهم والضَّالين.
اكتشاف المزيد من عالم المعلومات
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.